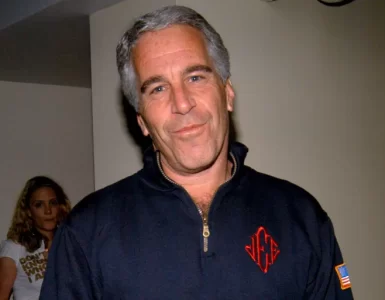ما الإضافة التي يمكن أن يقدّمها كاتب حينما يتحدث مجددا عن مذبحة ساهمت بعمق في إعادة صياغة وعيه ووجدانه؟! وكيف له أن يعود ويقارب حادثة من هذا النوع بالمعالجة الكتابية، وهو مرتبط بها بهذا القدر من العاطفة والتأثّر؟! والحق، أن مذبحة رابعة العدوية، أكبر من أن تخضع بسهولة لأي معالجة باردة وعقلانية، وهي من هذه الجهة أوسع من اللغة، ويمكن لنا في هذا المقام أن نشكر النّفري، الذي أسعفنا بقوله: “إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة”، وهي المقولة التي تخفف عنّا قليلاً من وحشة العجز، حينما نصطدم بهول وجوديّ، ولحظة بالغة الكثافة، سواء كانت رؤيتنا واسعة، أم مشوشة إلى درجة لا نتبين فيها أبعادها.
وهذا الارتباط العاطفي يحيل هذه الأحداث الكبرى، إلى مسائل ذات بعد شخصي، لأنها تتحول من موضوعة خارجية، متعينة في الواقع، تخضع للنقاش والتحليل، إلى إحساس يستبد بالأعماق، ويتسلط على قدرات المرء العصبية، وإمكاناته الذهنية، وغالبًا فإن المشاعر التي تبلغ هذه الغاية من الهيمنة على كيان الإنسان، لا تجد حاجتها في شيء، وتجد خيبتها في اللغة، فيطوي الإنسان على ذلك الموج، الذي يهدر في داخله بصمت جارح.
أي شيء يمكن أن نحلله بخصوص مذبحة رابعة؟! ثمة قداسة لهذا الهول الوجوديّ، وانعكاسه العميق في دواخلنا، تجعل الحدث عصيًّا على التحليل حتى لا ينتقص التحليل من هيبتها وحرارتها ومعانيها الكثيفة، وثمة خيط رفيع بين المعالجة العقلانية، وحرمة المشاعر الصادقة، وجلال المواقف النقية بانحيازها للمظلوم، وثمة مسؤولية أخلاقية بألا تتحول مهنة الكاتب، أو المثقف المعقب على الشأن العام، إلى ثرثرة استرزاقية لا تلحظ تلك القداسة، ولا تراعي تلك الحرمة.
ولتفسير الأحداث، التي تكتنز أبعادا قيمية وأخلاقية، رائحة غير طيبة، فيها ما يجرح الضحية، وما يفضح النقص الأخلاقي عند المعقب على الشأن العام، لأن الحدود الفاصلة ما بين التفسير والتبرير متداخلة، ولأن مهمة التفسير تتطلب قدرًا من البرودة المؤذية للمظلوم، ولأن انتقاد الحسابات الخاطئة لصاحب الجثّة المحترقة والمهروسة بدبابات الطاغية، قد يتحول بسبب ارتباك اللغة، أو الهوى الكامن فيها، إلى إدانة ما للمظلوم.
وحينما يكون الحدث حساسًا إلى هذه الدرجة، وشخصيا إلى هذا الحدّ، وعاطفيا بهذا القدر، فإنّ المعالجة الشخصية انبثاق طبيعي عن تلك الحيثيات كلها، حتى يبدو الأمر وكأننا نتحدث عن أنفسنا، ولكننا في الحقيقة نتحدث عن أثر الحدث فينا، أي عن الحدث نفسه من وجه آخر، وفي حالة رابعة عن أثر الشهداء، عن بقيتهم التي استوطنت دواخلنا، واستصحبت معها قيمهم المتعالية، ولطالما رأيت أن حدث الشهادة، أجلّ من أن ندنسه بمقارباتنا القاصرة، وأن أصدق ما يمكن أن نفصح عنه، ذلك الأثر الغامض الذي يتركه فينا، وتلك القيم التي يبثها الشهداء فينا بخفّة وعنف في الوقت نفسه.
في حالة رابعة، نحن نتحدث في أقل الأحوال، عن مئات الشهداء، وهذه واحدة من جوانب مأساة الحدث، أي انعدام توثيق دقيق لعدد الشهداء، وهذا مما يعزز من الارتباط العاطفي بالشهداء، النبلاء، الذين تعامل معهم الطاغية وقطيعه المنحطّ كأكياس قمامة، وهنا يبزغ السؤال عن السرّ الغامض الذي يربط ملايين البشر في المسكونة كلها، بمئات لا يعرفونهم، ولا يعرفون شيئًا عنهم، ولكنهم تأثّروا بهم هذا التأثر البالغ.
فرابعة؛لم تكن جريمة فحسب، ولكن كانت هناك قضية، وكان لدى هؤلاء الآلاف المعتصمين وعي ما بتلك القضية، ومن ثم، كان هناك استعداد حقيقي للتضحية، وكانت هناك مبادرة، وإرادة للفعل وفعل، وإذن فإن التأثّر لم يكن شفقة، أو محض رحمة، ولكنه أيضًا انحياز لتلك الإرادة النبيلة والفعل الناجم عنها.
وكان هؤلاء يمثلون حلمنا، أو بدوا لنا في لحظة ازدهارهم قبل أن يقطفهم الطاغية، السدّ في وجه الردة والانتكاسة، والجدار الذي يمنع الثورة المضادة عن منطقتنا، ويحجز المكيدة الصهيونية عن غزة، وكنا في أعماقنا ندرك خطر اجتياحهم بجنود الطاغية، ولأن كثيرًا منا وهب عمره لهذه القضية منذ أن تفتح وعيه على الدنيا، كانت روحه كل يوم ترفرف في رابعة، سواء أحب الإخوان أم لا، وثق في حسن تدبير قيادتهم أم لا، إذ إن القضية ساعتها كانت قد تجاوزت الإخوان، وصارت أكبر منهم.. إنّها بقية حلمنا التي جذبت روحنا إلى فلكها، فكيف لا تكون رابعة قضية شخصية بعد ذلك؟!
بيد أن اجتياح رابعة بجنود الطاغية، وهو الحدث المتصل من التفويض إلى الرقص على أنغام “تسلم الأيادي”، أحال الحدث إلى هول وجوديّ، ليس فقط لأن مئات من المظلومين العزّل سُحقوا أمام الكاميرات، ولكن أيضًا لأننا بتنا أكثر وعيًا بسعة الانحطاط الآدمي، وأن المنحطين قادرون على المفاجأة دائمًا، وأن أصناف المنحطين تستعصي على الحصر.
الصورة التي ذكّرني بها الفيسبوك، وهي صورة جنديين مصريين يصطفان معًا، سعداء مبتسمين، والجثث المتفحمة من خلفهم، دفعتني للكتابة مجددًا عن رابعة، ولكن هذا الانحطاط المباشر، والفجّ والفاضح، يتوارى في ظل انحطاط الساكتين، الذين تمنعهم أخلاقهم الرديئة عن الانحياز للمظلوم الذي لا يشبههم، أو لا يجدون في نصرته مصالحهم، أو لأنهم يبعضونه لسبب ما، فكيف بقطعان الراقصين، ذلك الخليط البهائمي الفاجر؟ وكيف بمصاصي الدماء من المشايخ والدعاة والمثقفين والإعلاميين والساسة؟!
وتخيلوا المهزلة حينما نصف بعض هؤلاء المنحطين بالدعاة، فإلى أي شيء يدعون الناس؟ وكيف ولو لمرة واحدة لم تهزّهم آية يتلونها، أو حديث يروونه؟!
إنّ ذلك ما يجدر بنا أن نتوقف عنده، وأن نحلله بإدانة نتقصدها.