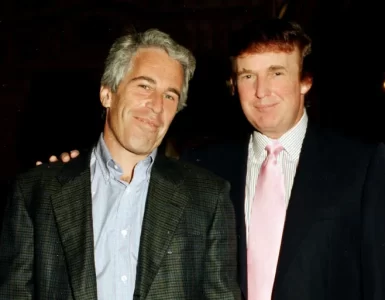تشاء الأقدار أن أعيش تلك التجربة، التي طالما قضّت مضجعي، ولا تذهب عن مخيلتي ليل نهار، وهي معاناة عشرات الآلاف من المعتقلين والثوار الذين يدفعون الثمن غاليا من حريتهم من أجل هذا الوطن ولحرية هذا الشعب.
كلنا على يقين أن الشهداء مصيرهم الجنة، وأنهم مختارون من المولى جلّ وعلا، ليجاوروا النبيين والصديقين في جنات ونهر، أما أولئك المختارون أيضا ليكون مصيرهم الأسر وتحمل ويلات العذاب المادي والمعنوي من سلطة إرهابية، فإنهم إلى جانب بلائهم وبلاء أسرهم الصابرة المحتسبة، يمثلون أيضا بلاء لفئة أخرى، تنتمي لطبقة الضمير، تشعر بهم وتحس بآلامهم وتناضل من أجل تخليصهم من هذا البلاء.
يأتي غربان الشر وجنود السطان فجرا، لاقتحام المنزل، ضابط صغير السن والقيمة أيضا، يقود عددا من الشبيحة، مدججين بالأسلحة، البعض مقنع والبعض لا، لا إذن نيابة ولا إذن قضاء، لا حرمة لمنزل ولا حرمة لأسرة ولا حرمة لمصري، تحت حكم نظام خياني، يكره بالضرورة المصريين ويعمل ضد مصالحهم.
يقتحم الإرهابيون المنزل، يدخلون بلا استئذان يوقظون الجميع، يطلب قائدهم صغير القامة والقيمة بصلافة ووقاحة، من والدي أستاذ الأدب العربي المرموق والناقد المعتبر في مجاله، أن ينهض من على السرير للتفتيش تحته، بينما تكيل والدتي الدعاء عليهم وهم لا ينطقون.
يعلم الهجامة الأشرار أن ما يفعلوه أبعد ما يكون عن الحق والحقيقة، فباعتراف كثيرن منهم يؤكدن أنهم لا ذنب لهم في ما يحدث لأنها الأوامر الصادرة باستقدام “فلان” واتهامه بتهم جاهزة يعلمها الجميع، ومع ذلك فإنهم مستمرون في ارتكاب الجريمة.
بعد الاعتقال يصطحبني عشرات الإرهابيين، إلى سيارة شرطة مملوكة للشعب وأنا جزء منه، تمضي السيارتان في القرية لجلب مزيد من الأبرياء، ومنذ وعيي على الحياة لم أشهد ولم يصل إلى علمي أن هناك مظاهرة واحدة نظمت في المركز كله، ناهيك بقرية يختفي البشر من شوارعها في حوالي الساعة التاسعة مساء، اللهم إلا مظاهرة، نادرة الحدوث، للتضامن مع فلسطين، وقت أن كنت في المدرسة الثانوية، شاركت فيها وذهبنا إلى مجلس المدينة حيث التقى بنا رئيسها.
تصل السيارة إلى بيت شيخ جليل، يعمل مفتشا بوزارة الأوقاف، ليحضره السرّاق من مخدعه إلى “البوكس” محمر العينين، لا يدرك ما الذي يحدث ولماذا أخذ من منزله، تدور القوة الهمجية للاتجاه إلى منزل شاب آخر يعمل إماما وخطيبا، و أمام ناظري، أشاهد عملية إرهاب السلطة ضد مواطنين أبرياء. لا يطرق الجناة الأبواب، يحمل أحدهم كتلة من الحجارة ويضرب بابا خشبيا حتى ينكسر، يدخلون، ينتشرون في المنزل، يرهبون أهل الضحية المنتظر، قبل استقدامه، تبكي الأم بحسرة وهم ينتزعون منها فلذة كبدها دون سبب ودون اتهام.
نذهب إلى منزل بريء آخر، لحرمانه من حريته، فلم يجدوه يأتي “الصغير” مغتاظا من عدم وجود ضحيته الرابعة، فالشهوة للظلم تتسع باتساع المدى الزمني للخدمة تحت إمرة الشيطان.
تخرج الميليشيا للمدينة “الأم” لتستقدم محاميا بلغ من العمر 65 عاما، عرفت في ما بعد ومن خلال المشاهدات أنه معلوم لدى القاصي والداني، يقدرونه ويحترمونه، سواء كانوا في الشرطة أو النيابة، أو المواطنين. عندما كنا في النيابة، كان الجميع يذهب لمصافحته والتضامن معه، محامون أمناء شرطة مواطنون، يتضامنون معه، لكنه العبث السائد، يعترف الجميع ببراءته، ومع ذلك يصمتون أيضا على محنته. فكل ما يحدث لا علاقة له بالقانون، أو حتى دستور 2014 الذي أقر تحت جنازير الدبابات وقصف الدعاية السوداء المسماة زورا فضائيات.
وصلنا إلى مركز الشرطة في حوالي الثانية والنصف صباحا، دخلنا نحن الأربعة الأبرياء إلى غرفة في الطابق الثاني، بها مكتبان إداريان، جلسنا على أريكة خشبية، كان أول ما وقعت عليه عيناي نتيجة ورقية تصدرتها الآية الكريمة “قل لن يصينا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون” كانت كلمة هو مولانا في مركز الصورة، وبالتالي أراحت البال وسكنّت الخاطر. بعد فترة طلبت دخول دورة المياه، وسمح لنا بسماحة أمين شرطة، في ما أعتقد. ذهبنا واحدا تلو الآخر، عندما عدنا قيدنا بالكلابشات، واعتذر لمفتش الأوقاف وهو يغلقها على يده “أنا أسف يا عم الشيخ”، تبادلنا أطراف الحديث مع الأمين ولحق به بعد فترة زميل آخر له، كان الجميع يتناقش سويا في أمور الحياة، إلى أن جاء الشبيحة، بعد فترة، برجلين آخرين، منهم واحد انضم إلينا وأصبحنا خمسة، وآخر ضبط بمسدس صوت. ظللنا على حالنا حتى الساعة السابعة والنصف تقريبا أنزلونا بعدها إلى الحجز في الطابق الأرضي، باب حديدي ضخم يكشف عن طرقة طويلة كئيبة المنظر، على جانبيها عدد من الأبواب الحديدية، أول ما ورد إلى ذهني، الأقفاص الخلفية في حديقة الحيوان التي تبيت بها الوحوش بعد نهار من العرض المهين أمام البشر.
في الزنزانة أو القبو الكئيب سيئ الرائحة، كان هناك ثلاثة أشخاص ينام اثنان منهم في ركنين من الغرفة، وثالث مستيقظ ينتظر إخلاء سبيله بعد 13 شهر حبسا عقوبة، في قضية حشيش، عرفت من خلال نقاشه مع الشخص المحتجز بمسدس صوت، أنه واع لما يحدث في مصر ويعرف كمية النصب والتزييف التي يمارسها الإعلام، ومدرك لفشل قائد الانقلاب ونظامه في النهوض بالبلد.
بعد نحو ساعة خرجنا من الزنزانة غير الآدمية، لسيارة الترحيلات التي لا تقل عداء للبشر عن القبو الذي كنا نحتجز فيه، أخرجنا من الحجز ضابط برتبة نقيب سيئ الخلق ووجه للبعض شتائم.
أول ما خرجت من باب المركز رأيت أمي وأختي، لوحت إليهما ولوحتا إليّ، لمست حقيقة المعاناة التي تعانيها أسر المعتقلين، ومدى الضرر الذي يلحق بهم، وتحول الإحساس المعنوي بآلام هؤلاء إلى إحساس على أرض الواقع.
في سيارة الترحيلات المنفرة انتابني شعور 37 شهيدا قضوا خنقا بالغاز نتيجة وحشية الميليشيا التي كانت تقلهم، عندما بدأ البعض في التدخين لم أتصور كيف لإنسان ينتمي لبني البشر، أن يطلق قنابل الغاز في علبة صفيح، بها 37 إنسانا لا يستطيعون التنفس في الظروف الطبيعية من عدة فتحات في جوانبها لإدخال الهواء.
حادث سيارة الترحيلات الرهيب، الذي تلا مذبحة رابعة المروعة بحق الإنسان، كان علامة فارقة على وحشية وإجرام سلطة 30 يونيو، في هذا اليوم فقدت مصر ما بقي من إنسانية، وانتزع منها الضمير.
في المحكمة صعدنا إلى النيابة في الطابق الثالث، أوقفونا مكبلين بجوار الحائط جاءت الأسر بالطعام والعصائر والماء، افترشنا الأرض من التعب في انتظار صنف أخر من صنوف أنصاف الألهة الذين ابتليت بهم مصر المحروسة، التي أصبحت خرابة في عهد انقلاب العسكر المشؤوم.
انتظرنا من حوالي التاسعة أو قبلها إلى ما قبل العصر، ونحن نفترش الأرض كان العديد من المواطنين في المحكمة والموظفين يأتون لإلقاء السلام، فهناك محام مقيد يعرفه الجميع، وإمام أيضا له شهرة معقولة ومكانة تسمح للناس بإعلان التعاطف وإلقاء كلمات الدعم والثبيت. كان الجميع يدرك المهزلة ويقرون بها.
عندما أدخلونا لوكيل النيابة، تجادلت معه كثيرا بعد معرفة التهم الموجه إلينا وهي تهم أحيكت بواسطة شيطان، كان أبرزها التظاهر الساعة عشرة ونصف ليلا، أمام مسجد القرية وحمل السلاح والمولوتوف ورفع لافتات تحرض على نظام الحكم، والمطالبة بإعلان الخلافة الإسلامية بقيادة الرئيس محمد مرسي، أجبرته في النهاية على الإقرار أمام الجميع بأن ما يحدث لا علاقة له بقانون، فهي بالنسبة إليه قضية سياسية، لا يمكنه فيها اتخاذ إجراء، وأمام الإصرار على عدم منطقية الحدث، تحدث بصفاقة وقال لي إذا تحدثت أكثر من ذلك “سأقل أدبي عليك”.
بعد ساعات من الإدلاء بالأقوال عدنا إلى مركز الشرطة مع أذان المغرب، لا نوم من يومين ولا راحة، ولا طعام رغم كثرة ما أحضر لنا، بعد ساعات وبعد تدخل نقابة الصحفيين وصدور بيانات عن مراكز حقوقية، وانتشار خبر الاعتقال في وسائل الإعلام وتضامن العديد من الزملاء والأصدقاء معي، تقرر إخلاء السبيل مع الأربعة الأبرياء، الذين لم يكن يعلم مصيرهم إلا الله، عندما هممنا بالخروج من القبو، نظرت إلى نافذة حديدية في قبو آخر بجاورنا وجدت من يلوح لي، كان أحد شباب القرية المحترمين معتقل منذ أربعة شهور، ويعمل صيدلي في وزارة الصحة، عندما رأيته أثار الموقف حزني، على مصيره، فكيف لإنسان أن يحيا في هذا المكان أربعة أشهر، وينتظر الحكم عليه في نفس التهم الموجهة إلينا، ووضع تاريخ حدث الاتهام له بعد أربعة أيام من الاعتقال، صافحته ودعوت له وبشرته بقرب الانتصار.
أربعة وعشرون ساعة كانت مختصرا لنحو أربعة وستين عاما من الحكم الإجرامي، ذلك الحكم العسكري البغيض الذي لم يجلب لمصر سوى الخراب وإهانة الإنسان، بدءا من عهد السفاح عبد الناصر وانتهاء بعهد السفاح السيسي، تمثل فيها الغياب المطلق للعدالة والكرامة والأمن، وكانت نموذجا لاحتقار المصريين، ظهرت فيها الطبقية والخسة والظلم وشهادة الزور، وكيف يسيطر أسوأ من في مصر على أفضل من فيها، وكيف يعلم الجميع براءتك وكيف يقومون بإدانتك.
هذه الصورة ليوم كامل من العذاب لا تعتبر شيئا يذكر، ويكون من الوقاحة مقارنتها، بتضحيات عشرات الآلاف من المصريين من أجل حرية هذا البلد، عمليات القتل والتعذيب والانتهاك والاعتقال والإهانة اليومة، مستمرة بحق هؤلاء، إذ يعتبرهم من في السلطة كائنات بلا حقوق، ومع كل هذه المأسي هناك من يقف مع سلطة النصب والدجل والشعوذة، ويردد في بلاهة “تسلم الأيادي”.
استمرار الحكم العسكري لن يدوم، والتضحيات مستمرة والثبات أسطوري، يوما ما سيحاكم كل هؤلاء القتلة المجرمين ويقتص الشعب منهم.