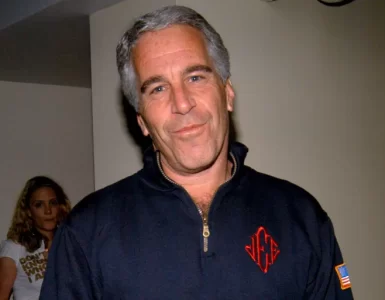لقد فرضت الديمقراطية نفسها على العالم كنظام أقلّ شرًا من باقي النظم منذ بداية العصر الحديث، وذلك بالتزامن مع التحول الجذري في مفهوم الدولة، وتبدل طبائع العمران وقواعد الاجتماع السياسي. وانتشرت أنظمتها في سائر القارات شرقًا وغربًا، وتبنتها غالبية دول العالم إما بالسلم أو بالانقلابات الثورية.
إن العالم العربي والإسلامي في علاقته بالديمقراطية -شأنه شأن غيره- لم يكن بوسعه التهرب من استحقاقاتها، والقفز عليها باعتبارها مرحلة ضرورية، أو على الأقل هكذا تبدو، في التاريخ البشري، حيث اتجه الكثير من العرب نحو الديمقراطية، وانفتحت أنظمتهم بدرجات متفاوتة القدر على الأساليب الديمقراطية، وآلياتها، فبعض الأنظمة اكتفت باستشارات شكلية على دساتير ونظم مشرعنة للاستبداد، والبعض الآخر تجاوز ذلك إلى بناء مؤسسات ديمقراطية كالمجالس النيابية، والاعتراف بالتعددية الحزبية، غير أنه ومهما تكن درجة الانفتاح، وحجم المكاسب الديمقراطية التي حققها العرب في المئة عام الماضية، فإن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها، ولا ينازع فيها أحد، هي أن الديمقراطية -مع حاجة العرب الماسة إليها- لا زالت تعاني من تعثرات كثيرة، تعوق رسوخها واستقرارها في البلاد العربية.
فقد دشنت عدد من الأنظمة العربية، وفي وقت مبكر، ما يسمى “الانتقال الديمقراطي”، وسعت بشكل رسمي وتوافقي مع أبرز القوى السياسية إلى إقرار ديمقراطية حقيقية، وبناء مؤسسات حكم ذات مصداقية، غير أن حصيلة هذا التوجه كانت متواضعة، ولم يؤد هذا المشروع إلى تأمين الديمقراطية ورسوخها، حيث عانى، وفي مرات عديدة من هزات وانتكاسات عنيفة، كانت تعود به إلى نقطة البداية.
ومن الحقائق الجديرة بالتأمل في هذا السياق، أن هذا التردد والتأرجح في علاقة الأنظمة العربية بالديمقراطية، وبصفة خاصة تلك التي عاشت مسلسلات الانتقال الديمقراطي، لم تستطع ثورات الربيع العربي بهزاته العنيفة والقوية حسمه، فبعد مدة قصيرة من ثوران الشارع، وانفتاحٍ على كُلِّ الديمقراطية، لوحظت صحوة جديدة لقوى الاستبداد، وعودة تدريجية لأوضاع ما قبل ثورات الربيع، وفي بعض الأحيان بعنف وصلافة لا نظير لها في العالم المتحضر، وهو ما عبر عنه الكثيرون بعودة التحكم، والنموذج السلطوي، أو الثورة المضادة.. إلخ.
إن إصرار الاستبداد على البقاء في البلاد العربية، ورفضه المغادرة، يوجه النظر إلى البحث عن الأسباب العميقة لهذه الصلابة الاستثنائية التي يتمتع بها في طبيعتنا العربية، وكأن تربتنا فقيرة لا تقبل بذور الديمقراطية، وتنبت -فقط- الاستبداد، الذي أمسى شرقيًا بالاسم، وعلامة مسجلة للعرب دون العالمين، حيث يشكل الوعي بهذه الأسباب العميقة المدخل الرئيس لبناء ديمقراطية حقيقية، وبأقل كلفة.
يقوم الاستبداد السياسي حيث ما وجد على مبدأ رئيس: هو الاستفراد بالسلطة والاستئثار بها دون الناس، ويتخذ أشكالًا وأوضاعًا مختلفة بحسب البلدان والثقافات، ولا يَكْمُل، ولا يتحقق على صعيد الواقع، من دون قابلية للاستبداد، قابلية نفسية، وثقافية، وسياسية لدى الشعب (أفرادًا وجماعات)؛ فالحاكم أو النظام المستبد لا سلطان له إذا لم يكن لديه «شعب مستبد»، ومعنى ذلك: شعب زاهد في السلطة، لا يرغب في ممارسة سيادته السياسية، سواء عبر الانتخاب أو أي وسيلة أخرى، شعب يعتبر السياسة مما لا يعنيه.
ومن ثم؛ فالتحول الديمقراطي التاريخي، القادر على بلوغ نهاياته، هو الذي لا يشتغل على البنية الفوقية للاستبداد فقط، بل يعزز ذلك بالاشتغال على بنياته التحتية، ويعمل على تفكيكها. ومما يلاحظ على الحركة الديمقراطية العربية تركيزها حد الهوس على الاستبداد السياسي الفوقي، وتساهلها مع دعامته التحتية، التي تحفظ استمراره، وترمم بنيانه عندما يتعرض للاختلال.
إن داء الاستبداد، ليس مرض الحكام وحدهم؛ بل مرض يصيب الشعوب أيضًا، فالأنظمة التي اقتنعت عن طواعية أو عن مضض بالاختيار الديمقراطي في الحكم، وأن استمرارها، واستقرارها مرتبط بالإصلاحات الديمقراطية، لا تواجه فقط نفسها أو بنيتها، وقد تكون هذه المعركة أسهل المعارك، ولكنها في الوقت نفسه تواجه شعبها، أو بمعنى آخر تواجه ثقافة الاستبداد المعشعشة في رؤوس قطاعات عريضة من أبناء الشعب، المتمثلة في العزوف والمقاطعة.. إلخ.
فمن أهم أعراض داء الاستبداد التي تعاني منها الشعوب العربية آفة العزوف الانتخابي، وعدم ذهاب المواطنين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة؛ وآفة ضعف انتظام المواطنين في الأحزاب والتيارات الإصلاحية الديمقراطية، وترجع هذه الآفات إلى سلطان اللا وعي على السلوك السياسي للمواطن، الذي يعتقد جازمًا أن الذي يحكم واحد أو جماعة معروفون، وأن هذه العملية المسماة ديمقراطية ما هي إلا لعبة مسرحية، لا جدية فيها، ومضيعة للوقت، ولا فائدة من ورائها، أو ربما فرصة سانحة لربح بعض الدريهمات من تجار الانتخابات.
إن هذا العزوف عن السياسة انتخابًا أو انتظامًا، يحمل في طياته بذور إجهاض التحول الديمقراطي، ومن شأنه أن يساهم في تمديد عمر الاستبداد، واستمرار إقصاء الأمة من المشاركة في تدبير شؤونها مع ما يترتب عن ذلك من أخطار استراتيجية تهدد فكرة الدولة في وطننا العربي، وتمهد للتفكك والصراع الطائفي والقبلي والمناطقي، ومن ثم؛ فالعمل الدؤوب من أجل إقناع المواطنين بالمشاركة في العملية الديمقراطية، والتفاعل معها، هو عمل يقع في صلب مشروع الانتقال الديمقراطي، ولعله في بعض الأوقات يفوق من حيث الأهمية المطالبة بتخلي الحكام عن بعض سلطاتهم.
إن العزوف السياسي كأحد أعراض الاستبداد السياسي لا يجب أن يختلط بموقف المقاطعة الانتخابية التي تدعو إليها بعض التيارات السياسية لكنه يتحالف معه؛ فالمقاطعة موقف سياسي «ديمقراطي» فيما نحسب، يتطلع إلى ظروف وشروط للمشاركة الديمقراطية غير متوفرة، غير أن أصحابها -مهما بلغوا من حيث القوة- لا يخاطبون بموقفهم العازفين، ولا يقربونهم من السياسة، بل على العكس من ذلك يشتغلون على المشاركين في المسلسل الديمقراطي على محدوديتهم، ومن هذه الناحية فهي تأخذ من سَلَّة المشاركة إلى سلَّة العزوف، الشيء الذي يرفع من رصيد الاستبداد، ويعزز إمكانياته من جهة، ويضعف من القوى الديمقراطية من جهة ثانية.
ومن ثم؛ فالمقاطعة في هذا السياق هي شكل من أشكال عرقلة الانتقال الديمقراطي، واصطفاف مع الاستبداد وقواه، ويزداد هذا المعنى وضوحًا، إذا علمنا أن أغلب دعاة المقاطعة هم قوى انتظارية، تعاني من اضطراب وغموض شديد في الرؤية؛ فلا هي بالقوى الثورية التي لديها مشروع ثورة ديمقراطية، ولا هي بقوى إصلاحية لها برنامج انتقال ديمقراطي بديل عما هو سائد، وأقصى ما تملكه هو التشغيب والتشويش على الموجود.